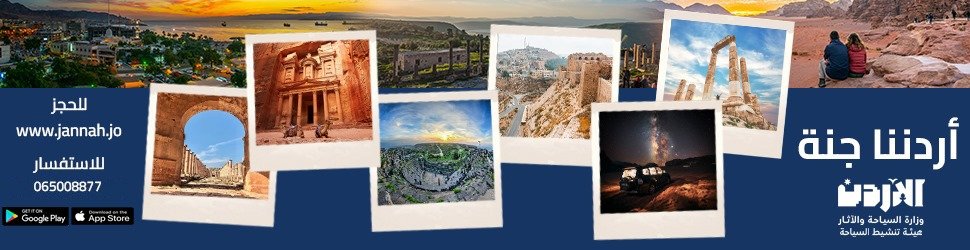توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الأردن ومصر في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يمثل خطوة ذات بعد استراتيجي يتجاوز تعزيز العلاقات الثنائية إلى إعادة تموضع اقتصادي في بيئة إقليمية مضطربة. فالأردن ومصر، يدركان أن النمو في المرحلة المقبلة لن يتحقق فقط عبر التبادل التجاري التقليدي، وإنما عبر تعميق التكامل في القطاعات القادرة على توليد القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
في قطاع الطاقة، يعكس التركيز على الربط الكهربائي وإمدادات الغاز سعياً لتأسيس سوق إقليمية للطاقة تتيح تبادلاً مرناً للإمدادات بين البلدين، وتحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية أو الانقطاعات المفاجئة. الأردن الذي يواجه تحديات في مزيج الطاقة واعتماده النسبي على الاستيراد، يرى في الربط مع مصر فرصة لتعزيز أمنه الطاقي وخفض كلف الإنتاج الصناعي. أما مصر، التي أصبحت مصدراً إقليمياً مهماً للغاز بعد تطوير حقول المتوسط، فإنها تستفيد من فتح مسارات تصدير جديدة تعزز عائدات النقد الأجنبي، وتدعم خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. هذا البعد ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي كوسيلة للتحوط ضد الصدمات الجيوسياسية.
الاتفاقيات الخاصة بالنقل والترانزيت تمثل بدورها تحركاً ضمن إستراتيجية أوسع لدمج الممرات التجارية الإقليمية. فالأردن، الذي يشكل حلقة وصل برية أساسية بين الخليج وبلاد الشام، يمكنه من خلال الربط المحسن مع الموانئ المصرية – خاصة عبر العقبة والسويس – أن يقدم بديلاً تنافسياً للمسارات البحرية الطويلة أو المعرضة للاضطرابات. هذا النوع من الربط اللوجستي يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويتيح للشركات العاملة في البلدين الوصول إلى أسواق أوسع بتكاليف أقل، وهو ما يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التغيرات التي أحدثتها الأزمات العالمية والحروب مؤخراً على هيكل التجارة العالمية.
في المجال الصناعي والاستثماري، توفر الاتفاقيات إطاراً للتكامل الإنتاجي بدلاً من التكرار التنافسي. إذ يمكن للقطاع الصناعي الأردني، بخبرته في الصناعات الدوائية والأسمدة وبعض الصناعات الخفيفة، أن يجد تكاملاً مع القدرات المصرية في الصناعات التحويلية الثقيلة والمنسوجات والبتروكيماويات. هذا التكامل، إذا ما تم عبر مناطق صناعية مشتركة أو سلاسل إنتاج موزعة، قد يتيح الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية التي يتمتع بها كل طرف، ما يعزز القدرة التنافسية ويخفض الحواجز الجمركية واللوجستية.
القطاع السياحي يمثل بعداً إضافياً في هذه الشراكة، إذ يمكن دمج الموارد السياحية للأردن ومصر في عروض سياحية إقليمية قادرة على جذب أسواق بعيدة المدى، خصوصاً في آسيا وأمريكا اللاتينية. هذا الدمج، إذا ما تم دعمه بخطط تسويق موحدة وشبكات طيران منخفضة الكلفة، قد يحول البلدين إلى محور سياحي تكاملي، بدلاً من تنافسية غير منتجة.
على الصعيد الكلي، يخلق التوافق السياسي بين عمان والقاهرة بيئة مؤسسية مستقرة، وهو عنصر نادر نسبياً في المنطقة، ما يمنح هذه الاتفاقيات فرصة أكبر للتحول إلى نتائج ملموسة. غير أن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل مرهوناً بقدرة البلدين على الانتقال من التفاهمات البروتوكولية إلى آليات تنفيذية مرتبطة بأهداف كمية، مثل زيادة حجم التجارة البينية بنسبة محددة خلال ثلاث سنوات، أو رفع الاستثمارات المشتركة إلى مستوى معين في أفق متوسط.
وتكتسب هذه الاتفاقيات بعداً إضافياً عند قراءتها في سياق أولويات الإنفاق الرأسمالي ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي” في الأردن، والتي تركز على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والصناعة. فالربط الكهربائي وتطوير الممرات اللوجستية وتوسيع الشراكات الصناعية يتقاطع مباشرة مع مشاريع الرؤية التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته الإنتاجية. كما أن توجيه جزء من الإنفاق الرأسمالي نحو تفعيل هذه الاتفاقيات سيضاعف من عوائدها الاقتصادية، إذ يتيح استغلال التمويل العام كرافعة لجذب استثمارات خاصة مشتركة مع الجانب المصري، ما يخلق أثراً مضاعفاً على النمو وفرص العمل، ويسهم في تسريع تحقيق الأهداف الكمية للرؤية، سواء في زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو تحسين تنافسية الاقتصاد الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
إذا ما أُدير هذا المسار بفاعلية، يمكن أن تتحول الشراكة الأردنية المصرية إلى منصة متقدمة للتكامل الإقليمي، مستفيدة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة والعلاقات السياسية المستقرة، لتقليل انكشاف البلدين على المخاطر الخارجية، وزيادة قدرتهما على المنافسة في بيئة اقتصادية عالمية تزداد تقلباً وتنافسية.
“الرأي”