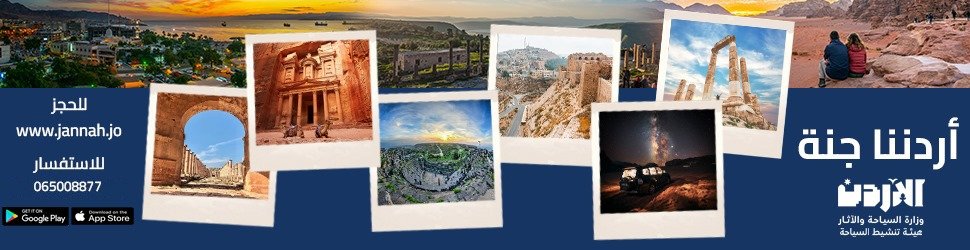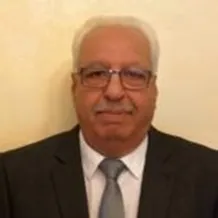عندما نتحدث عن جذب الاستثمار، فإننا نتحدث عن مستقبل الاقتصاد وفرص الشباب ونجاح رؤية التحديث الاقتصادي.
من وجهة نظري، الأردن يمتلك ميزات تنافسية حقيقية، لكن ما نزال بحاجة إلى إدارة أكثر فاعلية لهذه الفرص وتحويلها إلى قصص نجاح.
الأردن بلد يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعله حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يمنحه ميزة في الخدمات اللوجستية والتجارة وإعادة التصدير. الاستقرار السياسي والأمني في وسط إقليم مضطرب يمثل بحد ذاته عامل جذب نادرا في المنطقة.
إلى جانب ذلك، الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الأردن مع أسواق كبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، تمنح المستثمر أفضلية تصديرية يصعب العثور عليها في مكان آخر. كذلك، الموارد البشرية المؤهلة، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمات، تشكل رصيداً لا يقدر بثمن.
هذه المقومات وحدها قادرة على أن تجعل الأردن بيئة استثمارية رائدة. لكن، ومن تجربتي في متابعة المشهد الاقتصادي، أرى أن التحدي الحقيقي يكمن في البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار. هذه التحديات غالباً ما تُفقد المستثمر حماسه وتدفعه للبحث عن وجهات أخرى أكثر مرونة.
ما يلفت الانتباه أن جلالة الملك عبد الله الثاني لا يدخر جهداً في الترويج للأردن على الساحة الدولية، سواء من خلال لقاءاته مع قادة العالم أو اجتماعاته مع كبرى الشركات العالمية. جلالته يتصدر مشهد جذب الاستثمار ويبعث برسالة ثقة واضحة للعالم. لكن في المقابل، لا نرى جهداً موازياً بالقدر الكافي من المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن الاستثمار، سواء في تذليل العقبات البيروقراطية أو تسريع الإجراءات أو تقديم خدمة استثمارية مرنة وعصرية ومتقدمة.
وعند مقارنة تجربتنا بتجارب ناجحة، نجد أن الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال بفضل وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ. الإمارات لم تكتفِ بالترويج، بل طورت بنية تحتية متقدمة، أنشأت مناطق حرة متخصصة، وعملت على تبسيط بيئة الأعمال بشكل جعلها صديقة للمستثمر.
الأردن يملك مقومات لا تقل أهمية، ولا بد أن تُترجم تحركات القيادة السياسية إلى إجراءات ملموسة على الأرض. عندها فقط سنتمكن من تحويل الأردن إلى قصة نجاح استثماري حقيقية.
“الغد”