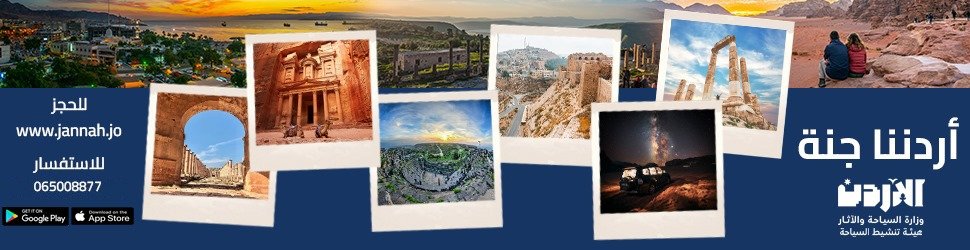في عالمٍ تتسارع فيه التحولات المالية، تقف العملات الوطنية أمام اختبار غير مسبوق، إذ تتجه الاقتصادات الكبرى إلى إطلاق عملاتها الرقمية عبر البنوك المركزية (CBDC)، وتستحوذ العملات المشفَّرة والمستقرة على حصة متنامية من المعاملات العالمية، ليجد الأردن نفسه أمام مفترق طرق حاسم. فالدينار الأردني، الذي ظل مرتبطًا بالدولار الأمريكي عند مستوى 0.709 دينار لعقود، حافظ على استقراره بفضل سياسات نقدية حذرة، لكنه يواجه اليوم تحديات وفرصًا جديدة تفرضها الثورة الرقمية في عالم المال. هذه ليست مجرد قصة عن التكنولوجيا المالية، بل عن توازنٍ دقيق بين الحفاظ على الاستقرار النقدي والانخراط في منظومة مالية عالمية يُعاد تشكيلها من الصفر، وعن سؤال جوهري: هل يتمكن الأردن من حماية مكانة الدينار وتعزيز دوره الإقليمي، أم أن موجة الرقمنة ستفرض قواعد جديدة لا يمكن تجاهلها؟
على مدى العقود الماضية، كان الدينار الأردني مرادفًا للاستقرار النقدي في منطقة تتسم بالتقلبات السياسية والاقتصادية. فمنذ منتصف التسعينيات، ضمن الربط بالدولار مظلةً من الثقة، حافظت على القوة الشرائية، وحدّت من تأثير موجات التضخم الإقليمي. إلا أن المشهد المالي العالمي اليوم يُعاد تشكيله بعمق، حيث لم تعد التقنيات المالية الناشئة، مثل البلوكشين والعملات الرقمية للبنوك المركزية، مجرد أدوات تجريبية، بل صارت في صميم السياسات النقدية لأكبر الاقتصادات. وقد شهد العقد الأخير تحوّل حركة الأموال عبر الحدود من مسارٍ بطيء ومكلف إلى منظومة أكثر سرعة وانسيابية، مدفوعة بابتكارات التكنولوجيا المالية وتغيرات السياسات النقدية. العملات المشفَّرة، التي بدأت كهواية تقنية محدودة، تحوّلت إلى أداة تداول وتخزين قيمة تستخدمها شركات كبرى وأسواق ناشئة، بينما فرضت العملات المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار أو الذهب، نفسها كجسر رقمي بين النظام المالي التقليدي وعالم التمويل اللامركزي. وفي الوقت ذاته، تسارع البنوك المركزية لإطلاق عملاتها الرقمية الرسمية، بهدف السيطرة على تدفقات الأموال وتعزيز الشفافية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. هذه التحولات لا تغيّر فقط طريقة الدفع، بل تعيد رسم ملامح المنافسة النقدية بين الدول، وتفرض على الاقتصادات النامية مثل الأردن إعادة تقييم استراتيجياتها النقدية وموقعها في هذا النظام العالمي الجديد.
يعتمد الأردن بصورةٍ ملحوظة على تحويلات المغتربين؛ إذ سجّلت نحو ٢٫٩ مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من ٢٠٢٤، وقرابة ٣٫٦ مليارات دولار للعام بأكمله، ضمن اقتصادٍ يُقدَّر ناتجه المحلي الإجمالي بنحو ٥٣٫٣ مليار دولار. وعلى صعيد الاستخدام الفعلي للقنوات الرقمية، تُظهر دراسة الشمول المالي أنّ استخدام المدفوعات الرقمية بلغ ٣٩٫٨٪ من البالغين في ٢٠٢٢، فيما وصلت ملكية الحسابات إلى ٤٣٫١٪ فقط، مع استهداف رفع الاستخدام إلى ٦٥٪ بحلول ٢٠٢٨. وبشأن كلفة التحويلات، تُسجّل قواعد الأسعار العالمية متوسطًا يقارب ٣٫٨٨٪ عبر محافظ الهاتف و٤٫١١٪ عبر بطاقات الخصم/الائتمان في الربع الرابع ٢٠٢٤ (وكان ٤٫٦١٪ و٥٫٠٠٪ على التوالي في الربع الأول ٢٠٢٤)، بما يعكس فرصةً واقعية لخفض الكلفة عبر تحسين الربط الإقليمي وتوسيع القبول الرقمي.
تحمل هذه التحوّلات الرقمية للأردن وجهين متقابلين؛ فمن جهة، يتيح تعميم التقنيات الحديثة تسريع التحويلات وجذب الاستثمارات، ولا سيّما مع موقع المملكة كمحورٍ يربط الخليج بالمشرق وأوروبا. ومن جهةٍ أخرى، يثير إدماج العملات الرسمية الرقمية أو الانخراط الأوسع في منظومات دفع إقليمية ودولية أسئلةً تتصل بالسيادة النقدية وحماية البيانات الحسّاسة. وتشير تقارير دولية إلى أنّ البنية التحتية للدفع في الأردن متقدمة تقنيًا، لكنها ما تزال تصطدم بعوائق ثقافية وتجارية تحدّ من الانتشار الواسع، فيما يعكس ضعف الإقبال على المحافظ الرقمية فجوةً في الثقة أو في القيمة العملية المتخيَّلة لدى المستخدمين والتجّار.
وعند تفكيك الصورة التشغيلية تتضح التحوّلات بالأرقام. شهدت منظومة المدفوعات الوطنية في ٢٠٢٤ نشاطًا مرتفعًا يعكس عمق الرقمنة؛ إذ بلغ إجمالي المعاملات عبر أنظمة شركة المدفوعات والتقاص الأردنية (JoPACC) ٢٢٤٫٦٢ مليون معاملة بقيمة ٧٩٫٩٥ مليار دينار. سجّل “CliQ” ٨٣٫٩٥ مليون معاملة بقيمة ١٢٫١ مليار دينار، و”JoMoPay” ٥٦٫٧٩ مليون معاملة بقيمة ٥٫٢٣ مليارات دينار، و”eFAWATEERcom” ٦٦٫٠٧ مليون معاملة بقيمة ١٣٫١٩ مليار دينار منها ١٠٫٨٥ مليارات عبر القنوات الرقمية. وفي المقابل، حافظت قنوات المقاصة التقليدية على دورها؛ إذ نفّذ ACH بالدينار عمليات بقيمة ٩٫١٣ مليارات دينار، بينما بلغت قيمة الشيكات المصفّاة عبر ECCU ٤٠٫٣٠ مليار دينار. وعلى صعيد التدفقات الواردة، أنهت تحويلات العاملين العام عند نحو ٣٫٦ مليارات دولار، مؤكِّدةً وزنها في الحساب الجاري.
ولا تقتصر الصورة على مشهدٍ سنوي؛ فبيانات النصف الأول من ٢٠٢٥ تشير إلى استمرار الزخم. في الربع الثاني ارتفعت قيمة عمليات “CliQ” إلى ٤٫٧٢ مليارات دينار مقابل ٤٫١٧ مليارات في الربع الأول، وسجّلت “JoMoPay” ١٫٥٤ مليار دينار، وبلغت معاملات “eFAWATEERcom” ٣٫٨٣ مليارات دينار. واستقر أداء ACH عند ٢٫٣٥ مليار دينار، ووصلت قيمة الشيكات المصفّاة عبر ECCU إلى ٩٫٩٢ مليارات دينار. وعلى جانب التدفقات، حقّقت تحويلات العاملين ٨٣٧٫٦ مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى، بما يعزّز دورها في دعم السيولة والاستهلاك.
بهذا المعنى، لا يطرح التحوّل الرقمي سؤال “الاستبدال” بقدر ما يطرح سؤال “التركيب”: كيف يمكن للأردن أن يحافظ على صلابة ربط الدينار ويستثمر في الوقت نفسه بُنى الدفع الفوري والتسوية العابرة للحدود لتقليل الكلف وتسريع الحركة وتعميق الشمول؟ الإجابة لا تأتي دفعة واحدة، بل عبر مسارٍ تدريجي يراكم المكاسب التشغيلية، ويختبر أدوات سيادية جديدة بقدرٍ محسوب، ويعيد تعريف العلاقة بين استقرار السياسة النقدية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.
في المشهد الإقليمي المتحرّك تبدو المقارنة جلية؛ تمضي السعودية والإمارات في تجارب عابرة للحدود وتطوير أطر تنظيمية متقدمة، مما يمنحهما موقعًا مؤثرًا في صياغة معايير المدفوعات السيادية والخاصة. إزاء ذلك، لا يكفي للأردن الاكتفاء بالاستراتيجيات المعلنة؛ المطلوب تحويلها إلى برنامج تنفيذي يختبر التشغيل البيني إقليميًا ويُراكم مكاسب ملموسة في السرعة والكلفة والثقة، من دون المساس باستقرار ربط الدينار أو تحميل النظام المصرفي مخاطر غير محسوبة. وتبدأ الخطوة العملية بتحديث الإطار التشريعي والتقني: تعريف محكم للعملة الرقمية الرسمية، وربط منظومة المدفوعات بحماية الخصوصية والبيانات وحقوق المتعاملين، مع تبسيط إجراءات التحقق الإلكتروني من الهوية. ويتوازى ذلك مع تعزيز متطلبات الأمن السيبراني، واعتماد معيار ISO 20022 لتبادل رسائل الدفع، وتوحيد معايير الربط المصرفي المفتوح بحيث تُدمَج المصرفية المفتوحة في البنية القائمة بوصفها وظيفة أصيلة لا مشروعًا منفصلًا.
وعلى مستوى البنية، تُستكمَل حلقات التشغيل البيني بين الأنظمة الوطنية (الفوري، المحافظ، الفواتير، المقاصة) عبر بوابات تكامل موحّدة، مع توحيد معايير القبول لدى التجار من رمزٍ سريع واحد ومعايير تحصيل شفافة حتى تنخفض كلفة القبول الرقمي وتتّسع تغطيته جغرافيًا وقطاعيًا. وفي الخلفية، يجري تثبيت “سلسلة الثقة” التقنية عبر الهوية والتوقيع الرقمي، وربطها بسجلات وطنية قابلة للتدقيق، تراعي مبدأ الحدّ الأدنى من البيانات المتبادلة.
بعد ذلك يصبح الاختبار السيادي ممكنًا وبخطوات صغيرة محسوبة. يمكن البدء بتسوياتٍ بالجملة محدودة النطاق بين البنوك محليًا ومع قنوات إقليمية فاعلة، بما يسمح بقياس أثر الزمن والكلفة والمخاطر التشغيلية في بيئة مضبوطة. يلي ذلك إثبات مفهومٍ موجه للتجزئة في سيناريو ذي أثر مباشر كحوالات العاملين أو دفعات حكومية صغيرة على شريحة مستهدفة، مع مؤشرات أداء واضحة لقياس زمن التسوية، وكلفة العملية، ونِسب الاعتماد، ومعدلات الخطأ والنزاعات.
ويظلّ النجاح رهنَ الشراكات الذكية. فتعميق الربط مع قنوات التسوية الإقليمية، والتعاقد مع مزوّدي خدمات تحويل رئيسيين في ممرات المغتربين، وإشراك الجامعات ومسرّعات التكنولوجيا المالية في تصميم حلول الهوية والامتثال، جميعها خطوات تعزّز فرص خفض الكلفة وتسريع الانتشار. وبالقدر نفسه من الأهمية، تُدار المخاطر بمنطق “الخصوصية بالتصميم” وكوابح الاستقرار المالي: أرصدة وحدود معاملات متدرجة بحسب مستويات التعرّف على الهوية، وعدم إتاحة عائدٍ على الأرصدة حتى لا تُزاح الودائع، وخطط تعافٍ وتشغيل مستمر، ورسائل تواصل عامة واضحة تقلّل الالتباس وتبني الثقة.
بهذه المقاربة يتحوّل السؤال من «هل ينخرط الأردن؟» إلى «كيف ينخرط بحكمة؟». جوهر الإجابة هو الجمع بين صلابة السياسة النقدية والإفادة من التحوّل الرقمي حيث يحقق قيمةً مضافةً قابلةً للقياس: حوالات أسرع وأرخص، وقبول تجاري أوسع، وشفافية أعلى في التسويات، ومعايير تشغيل يمكن تصديرها إقليميًا. وعندما تتراكم هذه اللبنات، يغدو الدينار ليس عنوانًا للاستقرار فحسب، بل أيضًا أداةً فاعلةً في اقتصادٍ رقمي تُصاغ قواعده الآن.